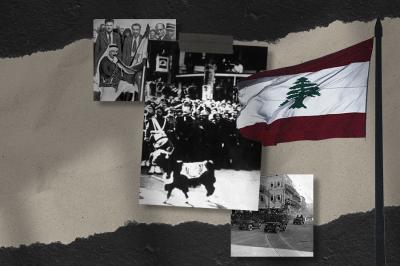منذ أن أدرك الإنسان وجود "غد"، وهو يسعى يائساً إلى اقتحام سور الغيب والتحايل على المجهول.
هي رحلة قديمة قِدم الخوف، تبدأ من همسات كهنة بابل تحت رصد النجوم، وتصل إلى رسومات القهوة الغامضة في مقاهي بيروت الصاخبة. تتغير الأدوات من كهوف اليونان القديمة إلى داتا الأجيال الجديدة. لكن الهوس بالسيطرة على ما لم يحدث بعد يبقى هو الحافز الأبدي.
فهل التبصير طاقة خفيّة أم مجرد انعكاس باهر لقلقنا الجماعي؟
عرفت الشعوب القديمة أشكالاً متعدّدة من التبصير، حيث لم يكن الأمر مجرّد تنجيم، بل لغة سياسية تُشيرعن حُكم الآلهة على الأرض.
في بابل ومصر القديمة، كان الكهنة يقرأون النجوم وحركة الطيور لتفسير إرادة الآلهة.
وفي اليونان، لم تكن النبوءات مجرّد كلمات، بل ألغاز تمنح رجال السُلطة مفتاح تفسيرها.
وفي المشرق العربي، تحوّل الغيب إلى طقس حميمي. توارثت الأجيال طرقاً مختلفة لقراءته، من الكفّ إلى الرمل، قبل أن تستولي "سلطانة القهوة" على المشهد، حيث تُعدّ قراءة الفنجان اليوم، التي يُقال إن أصولها تعود إلى القرن السابع عشر، ليست مجرد مشروب، بل مَسرح رمزي، حيث يصبح القارئ قريباً من البوح والحدس.
تمنح أشكال ترسّبات القهوة القارىء رموزاً ذات دلالات عميقة: شكل القلب يصبح مخزناً للأمنيات المكبوتة، والعين نقطة ارتكاز للحسد أو المراقبة، والطيور تشير إلى الأخبار التي تُحلِّق نحو الشخص.
لكن هنا يصرخ علم النفس بأن هذا الفضاء ليس سوى ساحة إسقاط عظمى.
يرى علماء النفس أنّ هذه القراءات لا تستند إلى علم أو منطق، بل تعبّر عن الإسقاط النفسي والرغبات المكبوتة لدى الشخص. أي أنك في الحقيقة لا تقرأ المستقبل، بل تقرأ رغبات الشخص الذي أمامك وخوفه الأعمق. الفنجان لا يُضيء الغد، بل يُفجِّر الداخل.
يقول أحد علماء الاجتماع اللبنانيين إنَّ التبصير في العالم العربي "ليس مجرد خرافة، بل مؤشر نفسي على مستوى القلق الجماعي"، فكلما ازداد الخوف من الغد، ازدهرت مهنة من يدّعون القدرة على كشفه.
لهذا السبب تحديداً، يحافظ التبصير في لبنان ومعظم البلدان العربية على "امتياز النجاة". ففي المقاهي البيروتية، كانت جلسات قراءة الفنجان جزءاً من الحياة اليومية، تمتزج فيها النميمة بالفضول. ومع مرور الزمن، تحوّلت إلى ظاهرة إعلامية وتجارية، خصوصاً مع انتشار البرامج التي تستضيف "عرّافين" و"منجّمين" يبيعون الأمل تحت الضغط.
في الأديان السماوية، يُعتبر ادعاء معرفة الغيب محرّماً، لأن الغيب من اختصاص الخالق وحده. ومع ذلك، يميّز بعض العلماء بين الحدس أو الفراسة (وهي نوع من الإلهام الطبيعي يعتمد على قراءة دقيقة للحاضر وسلوك الناس) وبين التبصير المزعوم الذي يتجاوز ذلك بادعاء ما لم يقع بعد.
علم النفس الحديث ينظر إلى التبصير على أنه آلية دفاع نفسي تساعد الأفراد على التكيّف مع القلق. عندما يعجز الإنسان عن السيطرة على واقعه، يبحث عن "إشارة" تمنحه شعوراً بالاطمئنان. ولذلك تنتعش مهن التبصير في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يزداد القلق الجماعي ويبحث الناس عن الأمل في المجهول.
يواجه التبصير التقليدي اليوم منافساً شرساً، وهو "التبصير العلمي".
في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ظهرت أشكال جديدة من "التنبؤ"، لكن على أسس علمية. فالشركات والمنصّات الرقمية تتنبأ بسلوك المستخدمين من خلال خوارزميات تحليل البيانات. هنا يصبح "التبصير" علماً حديثاً بلغة الأرقام، لا بالحدس ولا بالفنجان.
السؤال هنا لم يعد "هل يحدث؟" بل "هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكسر شيفرة القدر، أم أنه يكتفي بترجمتها بلغة حديثة باردة؟"
في الختام، تبقى ظاهرة قراءة الغيب ملحمة إنسانية بامتياز. بين الإيمان والخيال وبين الحاجة إلى الأمان والرغبة في السيطرة، قد لا تكشف لنا الأبراج والفناجين أسرار الغد، لكنها تكشفنا نحن في أعمق صورنا، تكشف خوفنا العاري وحبّنا الجارف وتوقنا الأبدي للأمان.
التبصير ليس أداة للسيطرة على المستقبل، بل هو مرآة ساحرة لقراءة الحاضر، ووسيلة للبوح المشترك، وطريقة لإدارة قلقنا أمام سيل المجهول. وبقي السؤال…. هل سنكفّ يوماً عن البحث عن "إشارة" في هذا العالم العشوائي؟
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
 سياسة
سياسة