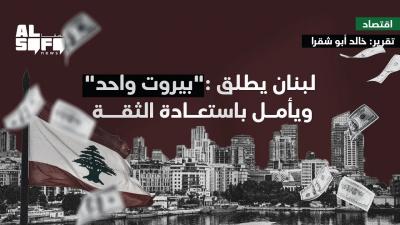في الذكرى السّنويّة الثانية لـ"انتصار" حركة طالبان إثر انسحاب القوّات العسكريّة الأميركية من أفغانستان بعد السنوات العشرين التي أمضتها في المنطقة، لا بدّ من تحليل المشهد السياسي الديني لدى كلّ من المجتمعات المسيحية والإسلامية. وليس أقلّه فحص منتجات الحضارة بمعناها الواسع من أجل استجلاء الأسباب التي تقف وراء تقدّم الغرب وقدرته المستمرّة على تطوير سلّم أولويّاته، مقابل تلك التي تقيّد الشّرق وتغرق أبناءه في عثرات تدفعهم دوماً خطوات إلى الوراء.
التساؤلات التي تطرح نفسها كثيرة، تتمحور بمعظمها حول كيفيّة تخطّي الغرب لحقبة العصور المظلمة التي كان يعيشها وتقدّمه على باقي الحضارات، وحول تراجع الحضارة العربية الإسلامية لترزح تحت عباءة الظلام والتدهور والانحطاط الفكري. وفي وقت تخلّص فيه الغرب من "الاستعمار الديني المسيحي"، كيف يمكن مقارنة "الإسلام السياسي" مع "المسيحية السياسية"، وهل يكون فصل الدين عن الدولة السّبيل الوحيد للحدّ من الصّراع القائم بين الولاء للديّن من جهة وتسيير أمور الدولة من جهة أخرى؟
بين العصرين القديم والحديث
البداية مع الحقبات التّاريخية منذ ما قبل الميلاد وحتّى اليوم، والتي قسّمها المؤرّخون إلى ثلاثة عصور رئيسية:
- العصر القديم الممتدّ من العام 60,000 قبل الميلاد وحتى العام 500 ميلادي، والذي شهد تطوّر البشريّة وتعلّمها الكتابة والقراءة إضافة إلى ظهور بعض الحضارات وأبرزها اليونانية والفرعونية وبلاد ما بين النهرين، والتي لا تزال قائمة بآثارها الرائعة حتى عصرنا الحالي.
- العصور الوسطى الممتدّة من العام 500 حتى العام 1500 ميلادي. وقد بدأت هذه الحقبة منذ سقوط الحضارة الرومانية، كما عُرفت أيضاً بـ"العصور المظلمة" نتيجة الظلام الفكري الذي ساد أوروبا آنذاك. هذا وأطلق الغربيّون هذه التسمية للدلالة على الجهل والظلام الشديدين اللذين تسبّبت بهما سلطة الكنيسة. بالمقابل كانت مساهمات المسلمين في تلك العصور متعدّدة في كافة المجالات، نذكر منها الفن والعمارة والطب والفلك والصيدلة والزراعة واللغة وغيرها.
- العصر الحديث الممتدّ من العام 1500 حتّى اليوم حيث تفوّقت الحضارة الأوروبية وامتدّت إلى كافّة الدّول المتحضّرة. إنّها فترة الحداثة التي ارتبطت بالكثير من التّغيّرات المتسارعة ومنها تراجع تأثير التقاليد الدينية على المجتمع.
ثورة فكرية تحطّم القيود الكنسية
في الواقع، ظلّ الاستبداد جاثماً على صدر الأوروبيين لعقود طويلة تحت شعارات مختلفة، منها هيبة الحاكم المطلقة أو سيطرة كهنوت الكنيسة اللامشروطة، إلى أن جاءت مواجهة الكنيسة كسبب رئيسي وراء الانفتاح السياسي والفكري والاجتماعي الذي أتاح للإنسان العيش بحرّيّة دون قيد أو ذلّ. كيف ذلك؟ نتيجة هذا الاستبداد، "انفجرت" معارضة فكرية تنافست من خلالها كتابات الهجاء مصوّبة سهامها ضدّ الظلم والإفراط في سوء استخدام السلطة. هكذا، وبالتزامن مع دعم شعبيّ كبير، تحوّلت هذه المعارضة إلى منظومة جديدة رفعت شعارات عدّة أهمّها تحسين الأوضاع الاجتماعية والتخلّص من الاستعباد والهيمنة والعديد من القيم الإنسانية ربّما يكون شعار الحرية أكثرها جاذبية.
من جهتهم، لعب عمّال المطابع والمكتبات دوراً بارزاً في نشر تلك الأفكار والشعارات الثوريّة، ما أدّى، في نهاية المطاف، إلى انهيار النّظام المستبدّ القائم وبداية عصر جديد. أمّا النتيجة فقد تبلورت جليّاً من خلال وثبات الأدب والفكر والثقافة المتقدمة، إذ تمّ القضاء على الخرافات الدينية بعد التحرّر بنجاح من السلطة الكنسية. هذا إضافة إلى ازدهار وتطوّر الحياة السياسية والصناعيّة والتجارية كما إطلاق الإبداع الفكري والعلمي في سابقة لا مثيل لها.
الأنظمة الإسلامية... تَحرّر أم صراع؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ فكرة فصل الدّين عن الدّولة طالما شكّلت جدليّة كبيرة في الفكر الغربي قبل أن يتمّ احتضانها بشكل كامل من الشعوب في ما بعد. وحين تمّ استيرادها إلى العالم العربي "الإسلامي" ظهرت إشكالات عنيفة وصراعات حادّة على خلفية علاقة الشّريعة الإسلامية بالسلطة، فالإسلام نظام حكم أو دين ودولة كما يصفه أتباع العقيدة الإسلامية. هذا إضافة إلى أنّ رافضي مبدأ فصل الدّين عن الدّولة يرون في الغرب سقطة روحية ومعنوية وقيمية ترافقت مع انعدام المبادئ الإنسانية وطغيان المادّة على ما سواها، ما يحتّم عدم الامتثال به والحذو حذوه.
في الحقيقة، كثيرة هي الدّول التي تتمتّع بأنظمة حكم إسلامية واضحة المعالم، ولا يخفى على أحد أنّ بعضها ما زال يواجه أزمات وصعوبة في التوفيق بين الولاء الديني وتسيير شؤون الدولة ولو بالحدّ الأدنى. بالمقابل، نجحت دول أخرى في تخطّي هذه الحواجز على غرار المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربيّة المتّحدة التي تمكّنت الحفاظ على هويتها الإسلامية مع ولوج عالم الحداثة والتطوير، في ما بدا وكأنّه فصل لنظام الحكم وتسيير شؤون البلاد عن العقيدة كممارسة وفعل حياة، وها هي دول عربية وإسلامية عديدة تخطو بهذا الاتجاه في محاولة لتحصين المجتمع وطقوسه ولكن ليس على حساب التطوّر والحضارة والرّخاء، وهنا يكمن التحدّي الحقيقي.
أفغانستان... الدّولة المأزومة

بناءً لما تقدّم، لا بدّ من التساؤل ما إذا كان فصل الدّين عن الدولة شرطاً أساسياً لأيّ نهضة حضارية جديدة أم أنّه ضياع للهوية، وبالأخصّ تلك العربية الإسلامية.
بالعودة إلى أفغانستان التي تتحضّر للاحتفال بذكرى انسحاب القوات الأميركية من أراضيها في آب 2021، لا بد من طرح السّؤال: هل تمكّنت حكومة طالبان التي تحكم البلد حالياً من إقامة منظومة كاملة متكاملة لبناء دولة قابلة للحياة؟ وكيف يمكن لهذه الدولة الغنيّة بثرواتها المعدنية والطبيعية والتي تزيد مساحتها عن 650 ألف كم2 ويتخطّى عدد سكانها الـ45 مليون نسمة، أن تنهار بهذا الشكل الكارثي في غضون أقلّ من أسبوعين على الانسحاب الأميركي من أراضيها؟
هذا الأمر وإن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ تجربة طالبان في إدارة دولة حديثة محكوم عليها مسبقاً بالفشل. فبالرغم من "الاحترافية" التي تميزت بها الجماعات الإسلامية التي انخرطت لعقود طويلة في القتال ضد القوات الأمريكية - وقبلها السوفياتية – غير أنّها أثبتت افتقارها إلى المهارة والمعرفة في إدارة شؤون الدولة، لذا تراها حائرة في قراراتها ضمن المراوحة السّلبية في التناقضات والتوتّرات السياسيّة. كلّ ذلك بسبب إصرارها على فرض نظام اجتماعي سياسي طائفي يعود إلى العصور الوسطى، فهل من سبيل لتخطّي ذلك؟
على خطى الغرب سائرون
أزمة طالبان المبنيّة على محاولة التوفيق بين الولاء الديني وتسيير شؤون الدولة لا يمكن تخطيها إلّا بالانفتاح على العالم الخارجي، ما يتطلب التحوّل إلى السياسات البراغماتية قبل أن تفقد تماسكها كحركة مسيطرة. مع العلم أن قادتها بدأوا يشعرون بالقلق تجاه التحدي الذي تواجهه إيران، الدولة المجاورة، بعد أن تجاهلت بعض النساء الإيرانيات مؤخرًا، وبشكل علني، بعض القواعد الثابتة من التعاليم الإسلامية التي تفرضها الدولة (كالحجاب مثلاً). والخوف كلّ الخوف في أن يتدحرج هذا التحدّي إلى الداخل الأفغاني ككرة ثلج لا يمكن إيقافها.
بالمقابل، ورغم القلق العميق الذي يعكّر صفاء طالبان حيال مصير إمارتهم المولودة حديثاً، غير أنّها تشعر ببعض الأمان والراحة كون الشعب الأفغاني منهكاً كلّياً نتيجة جيلين أو أكثر لا زالوا يعيشون تبعات الصّراعات المستمرّة ويعانون من نتائجها الكارثية على كافة الصعد. لكنّ هذا لا يلغي ضرورة البحث عن سبل إنجاح النّظام إذ أنّه من غير الوارد أن تدوم هذه التناقضات المتشعّبة لفترة طويلة. فهل يكون فصل الدين عن الدولة هو الحلّ؟
صحيح أنّه ما من سبب جوهري يعيق وصول الثيوقراطيين (أي الحكّام الدينيين) إلى السلطة، لكن من الصعب ممارسة حكمهم دون تقديم التنازلات وتدوير الزوايا بشكل لا يتوافق نسبياً مع مبادئهم وعقائدهم الدينية. فالنظام الثيوقراطي الهجين سيعيش حكماً، خلال السنوات القليلة المقبلة، مخاض تغيير عالمي جذري، تماماً كالذي عاشته أنظمة دول الغرب قبل أن تتحرر من السلطة الكنسية. لكن أن تكون الولادة طبيعية أم قيصرية... فهذا أمر آخر.
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
 سياسة
سياسة