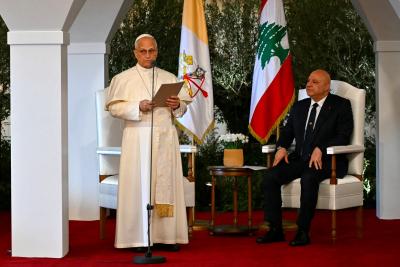قلّما جمعت علاقة طائفة بوطن كعلاقة الموارنة بلبنان. فهي أبعد من الدور الذي لعبه البطريرك الماروني الياس الحويك في قيام دولة لبنان الكبير عام 1920 أو بطريرك "الاستقلال الثاني" نصرالله بطرس صفير في جلاء الجيش السوري عام 2005. كما هي أبعد من دورهم كشريك مؤسّس لكيان جبل لبنان وتجربتي القائم مقاميتين والمتصرفية.
إنّها علاقة عشق وجداني وحلم تاريخي بمساحة حريّة عمرها من عمر نشأة الموارنة قبل 1400 عام مع بطريركهم الأول مار يوحنا مارون. لذا نجد هذا "اللبنان" وأرزته متجذّرين في طقوسهم الدينية وجوهر صلواتهم. فهم يتضرّعون إلى مريم العذراء كأرزة لبنان التي يرفعونها على مذابح كنائسهم وأثواب كهنتهم ورهبانهم. كما أنّ تقديرهم لعظمة هذا الكيان جعلهم يتوّجون بطاركتهم بـشعار "مجد لبنان أعطي له".
هذه الخصوصية للبنان في عمق عيش الموارنة لإيمانهم لم يعرفها أيّ مكوّن طائفيّ آخر في هذا الوطن أو حتّى في سواه. الأهمّ أنّهم لم يبحثوا يوماً عن قيام وطن للموارنة حصراً – كما اليهود في إسرائيل أو دعاة مشروع إقامة الأمّة الإسلامية - بل وطن حاضن لكلّ عاشق للحرية وباحث عن عيش إيمانه بعيداً عن أيّ قمع أو ذمّية في شرق يهوى عبر التاريخ خنق أي آخر مختلف.
لذا لا وجود في قاموس الموارنة لمواطن فئة أولى وآخر فئة ثانية، ولا تفوّق إثني ولا فوقية. لكن في المقابل، لم يرتضوا أن يكونوا كغيرهم من مسيحيي دول الجوار مواطنين فئة ثانية في الأوطان التي كانوا في أساسها. لم يكتفوا بالنّضال في سبيل الحفاظ على الوجود بل من أجل أن يتكامل هذا الوجود مع الدور.
اليوم، ثمّة من يقول إنّ الموارنة على مشارف خسارة الدور والوجود في لبنان والالتحاق بما حملته الألفية الثالثة من انهيار ديمغرافي وتصحّر وجودي للمسيحيين من العراق إلى سوريا والقدس. حتّى أنّ البعض يلومهم بشكل رئيسي على ما وصل إليه هذا "اللبنان" من خطر وجودي على الوطن والهوية والكيان. فهل تعب الموارنة من النضال؟ هل استسلموا أمام الذمّيّة في هذا الشرق والرفاهية أو أقلّه الحرية والاستقرار في الغرب؟
ثمّة من يقول إنّ الموارنة على مشارف خسارة الدور والوجود في لبنان والالتحاق بما حملته الألفية الثالثة من انهيار ديمغرافي وتصحّر وجودي للمسيحيين من العراق إلى سوريا والقدس
حكماً يمرّ الموارنة في أزمة، وبعضهم يرمي المسؤولية الأساس على ساستهم وصراعاتهم. لكنّ الموارنة عبر التاريخ عرفوا الصراعات في ما بينهم. ومثال على ذلك الصراع بين طانوس شاهين ويوسف بيك كرم في القرن التاسع عشر. لذا خسارة المسيحيين حرب 1975 التي يدفعون ثمنها حتّى هذه اللحظة تعود بشكل أساسي إلى شعبوية "طانوس شاهين القرن العشرين" الجنرال ميشال عون وإعلانه حرب تحرير "تنفيسة" وتتويجها بحرب إلغاء هي أشبه بثورة شاهين غير المدروسة، فكانت النتيجة انتهاء الحرب بغالب ومغلوب.
الأخطر هو تأرجح بعض ساستهم بين الذمّيّة والزبائنية. إلّا أنّهم أيضاً قدّموا في السنوات الأخيرة نموذجاً آخر يعكس صلابة الماروني وإيمانه بقضيّته عبر التاريخ، ورفضه الفرار من المواجهة تمثّل بسمير جعجع الذي عاش الانفرادي تحت ثالث أرض في وزارة الدفاع طوال 4114 يوماً، ولم يستسلم أمام ظلم أو يَنْهَرْ جرّاء ضغط.
كذلك لا يعفي هذا البعض الكنيسة المارونية ورهبانياتها من المسؤولية في هذه الأزمة، معتبراً أنّهما ليستا على مستوى المرحلة. لكن أيضاً عانى الموارنة في مراحل عدّة عبر التاريخ من التخبّط الكنسي كما في حقبة الراهبة هندية في القرن الثامن عشر ونجحوا في الخروج منه.
ما جاء أعلاه ليس من باب تبرئة الساسة ورجالات الدين من مسؤوليتهم، لكن من باب الدعوة إلى عدم التسليم بهذا الواقع أو إدمان جلد الذات والتأكيد أنّ بعد كلّ كبوة قيامة. مسافة زمنية قصيرة إلى الوراء قبل نصف قرن، تثبت أنّ ما زال بإمكان الموارنة الحفاظ على ثنائية الوجود والدور. صحيح أنّ طبيعة الخطر والمواجهة والتحدّيات تغيّرت، وكذلك موازين القوى بين المكوّنات، ولكن من مصلحة جميع هذه المكونات الحفاظ على هذا الوجود الماروني ودوره، وتلقائياً الوجود المسيحي، لأنّه "سرّ نكهة لبنان" مقارنة بدول الجوار.
في الحقيقة، لبنان اليوم لا يعاني فقط من أزمة الموارنة ومعهم المسيحيون، لكنّ الأزمات تعصف أيضاً بالمكوّنات الأخرى، وإن اختلفت أوجهها ووضع ساستهم ليس أفضل حالاً. المكوّن السُّني يعاني التخبّط والضياع وأزمة رجالات من قماشة الزعامات، وقد فضح ذلك تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي. في حين أضحت أزمة المكوّن الدرزي مستدامة كونه الأكثر اضمحلالاً من حيث الوجود في ظلّ الصيغة الطائفية التي تحكم البلاد.
قد يظنّ بعضهم أنّ المكوّن الشيعي في أفضل أيامه في ظل الشيعية السياسية ونموذج الثنائي الشيعي، إلّا أنّ الأزمة التي تصيب هذا المكون كامنة في أنّ "فائض القوة" الذي يشعر به و"العنجهية السياسية" التي يزهو بها يكادان يخنقانه في شرنقة نفوذه، لأنّ ممارساته تُراكم نقمة عليه من قبل باقي المكوّنات وقد تجعل منه مادة نفور وطني.
إلى كلّ هذه الأزمات، هنالك الخطر الأساسي الذي يعانيه لبنان وهو تراجع مستوى الحرية ونوعيّتها. فحرّيتي كفرد ومكوّن التي لا تقف عند حدود حرّية الآخر تشّكل خطراً على علّة وجود الوطن. فما حملات التخوين والصهينة للبطريرك بشارة بطرس الراعي أخيراً سوى انتهاك لحدود حرّية الآخر. سلفه البطريرك صفير قال يوماً "نحن الذين لجأنا إلى المغاور والكهوف في عهد الظلم والظلام طِوال مئات السنين لِيسلم لنا الإيمان بالله وعبادته على طريقتنا في هذه الجبال وعلى هذه الشواطئ ولتبقى لنا الحرية التي إذا عُدمناها عُدمنا الحياة". ليخلص بعدها قائلاً: "إذا خيّرونا بين العيش المشترك والحرية، نختار الحرية".فهل من يتّعظ؟
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
 سياسة
سياسة