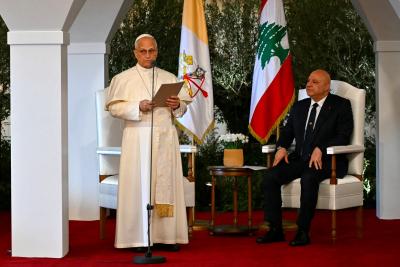لا يخفى أنّ جميع اللبنانيين باتوا على طرفَي نقيض، موزّعين بين خطّين متوازيَين لا يلتقيان، ولا فسحة بينهما للرماديّين أو من تمّ التعارف على تسميتهم ب"الوسطيين".
وكأنّ حرب الجنوب المندلعة منذ ما يقارب ستة أشهر، بقرار فردي وفئوي، ألغت المسافة الضيقة التي كان يتحرّك فيها هؤلاء، وآخرهم أهل مبادرة "تكتل الاعتدال" وبعض السعاة إلى التوافق من الداخل ومن الخارج، سواءٌّ على الملف الرئاسي أو على المخارج الممكنة من الأزمة، ولم يعُد هناك سوى خط تماس بين جبهتَين متصادمتَين، سياسياً واجتماعياً حتى إشعارٍ آخر.
هذا الانهدام، أو الفالق السياسي الاجتماعي، يؤسّس حكماً لحالة هجر أو فسخ عقد أو طلاق حُبّي، إلّا إذا حصلت صدمة وعي وطني في اللحظة الأخيرة تؤدّي إلى ترشيد قرار الانخراط في الحرب وتفادي الانزلاق الأخير.
وليس خافياً أن العودة إلى صيغة الحكم المتّبعة منذ ما بعد العام 2006، والقائمة على ثنائية السلاح والفساد، تحت ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة"، ومع البِدع الدستورية المتسلّلة بعد العام 2008، والنوم على مخدّة الفراغ المتكرّر في هرمية الدولة، ليست ممكنة ولا قابلة لإعادة الإنتاج أو التدوير.
وفي النتيجتَين اللتين يمكن أن تنتهي إليهما هذه الحرب، إنتصاراً ل"حزب الله" أو انكساراُ (والانتصار سيكون حُكماً بطعم الانكسار)، يستحيل ترميم تلك الصيغة أو ترقيعها، حتّى لو حاول المجتمع الدولي تمرير هذا الترميم كتسوية فوق الجمر على الطريقة اللبنانية المعهودة، بمنطق المقايضة بين وقف الحرب والتطمين الأمني لإسرائيل مقابل أثمان سياسية في السلطة، أو في التوازنات والشراكة، أو في الدستور والأعراف.
يستحيل ترميم تلك الصيغة أو ترقيعها، حتّى لو حاول المجتمع الدولي تمرير هذا الترميم كتسوية فوق الجمر
فالواقعية السياسية تفرض الاعتراف بأن القوى الشعبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية الرافضة لحرب "حزب الله" باتت وازنة بأغلبياتها العابرة للطوائف والأحزاب، بحيث تستطيع التصدّي لأي صفقة تكرّس يداً عليا فوق يد الدولة والشرعية، أو غلبة سياسية بقوة السلاح والأمر الواقع.
وهذه الواقعية نفسها توجب الانتباه إلى أن تصاعد النقمة ضد الحرب والسلاح غير الشرعي لا يأتي من فراغ، بل من إرادة شديدة الوضوح تطرح أحد خيارَين:
إمّا إعادة الحق الحصري باستخدام السلاح إلى الدولة مع تمتّعها المطلق بقرارها السيادي، وتكريس حيادها في الحروب.
وإمّا بلورة صيغة حكم جديدة تكفل حياةً حرة مستقرة لكلّ مكوّنات الوطن، سواءٌ سُمّيت لامركزية موسّعة أو فيدرالية أو مناطقية. ولا يمكن هنا إطلاق التهمة بالتقسيم، لإنّ هذه الصيغ الحديثة والعصرية أثبتت نجاحها في كل الدول ذات التركيب المتنوّع، ومن بينها نماذج عربية وعالمية بلغت شأواً متقدّماً في النمو والاستقرار والحضارة.
قد يكون "حزب الله"، ربّما من حيث لا يدري أو لا يريد، أسّس للدفع نحو اعتماد الصيغة الجديدة من خلال أمرَين:
الأوّل، أسبقيته في إدارة مناطق سيطرته وبيئته، أمنيّاً وماليّاً وتربويّاً وصحّياً وإيمانيّاً وتراثيّاً وثقافيّاً (نمط عيش وعادات وتقاليد بعضها طارىء على الموروث اللبناني).
والثاني، تفرّده في إعلان الحرب وإلزام بيئته بها ثمّ سائر اللبنانيّين، بحيث أفسح في المجال أمام رافضيّ هذا التفرّد، لرفع الصوت والدعوة إلى الانفكاك عن مساره الانتحاري.
والمعروف أن مشروعه الأساسي بحسب وثيقته التأسيسية الصادرة سنة 1985 هو إقامة "الجمهورية الإسلامية في لبنان" كفرع من فروع الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران، وقد اصطدم هذا المشروع بصلابة رفض داخلي لا يمكن التقليل من أهمّيته وقدرته.
ولا شكّ في أن "الحزب" مصدوم من فشل مشروعه الأكبر، ومن عدم تطابق حساب حقله الحربي الجنوبي مع حساب بيدره السياسي الداخلي، وتنعكس هذه الصدمة في الخطَب الأخيرة لأمينه العام السيّد حسن نصرالله، عبر انخفاض سقفها وارتباك عناوينها وغموض أهدافها.
والخروج من هذه الصدمة وهذَين الارتباك والغموض، يكون عبر الاعتراف الشجاع بالخطأ أو الخطيئة التزاماّ ب"نصيحة" مرجعيته البراغماتية، والعودة عنهما كفضيلة من فضائل الوعي والواقعية، وتالياً الإقفال النهائي على مشروعه المذكور.
وسيكون ثمن هذَين الاعتراف والعودة أقل بكثير من الثمن الثقيل الذي دفع جزءه الأوّل ضحايا ودماراً ونزوحاً، وسيدفع جزءه الثاني الأثقل، ويُدفّع لبنان جزاءً موجعاً، في حال استمراره بركوب مركب الحرب العبثية.
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
 سياسة
سياسة